

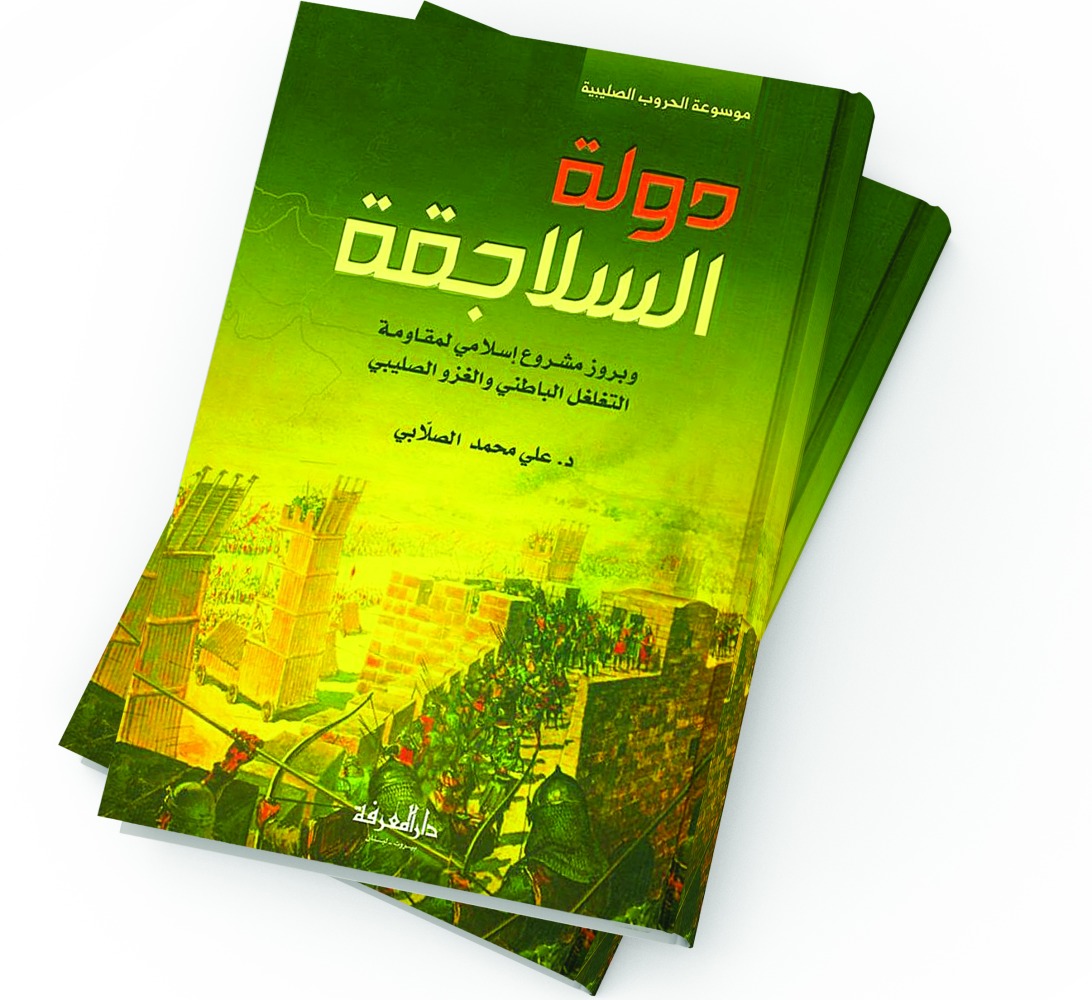
هذا الكتاب امتداد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة، وعهد الخلافة الراشدة، وقد صدر منها: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن عليٍّ، رضي اللهُ عَنْهُم جميعاً، والدولة الأموية. ويتناول الكتاب (دولة السلاجقة وبروز المشروع الإسلامي لمقاومة الغزو الصليبي) ويعتبر حلقة مهمة من ضمن سلسلة حلقات تاريخ أمتنا، والمتعلقة بالحروب الصليبية، والتي نسأل الله تعالى بأسمائهِ الحسنى، وصفاته العلا أن يوفقنا لإتمامها، وأن تكونَ خالصة لوجهه الكريم، ويطرح في كل الكتب القبول والبركة من عنده.
يتحدث هذا الكتاب في الفصل الأول: عن السلاجقة، وأصولهم، وسلاطينهم، ومواطنهم، وبداية ظهورهم، وعن اتصال الأتراك بالعالم الإسلامي، وعن المشرق الإسلامي قبيل ظهور السلاجقة، وعن الدولة السامانية، والغزنوية، والصراع الغزنوي السلجوقي، ومعركة دندانقان، وقيام السلطنة السلجوقية.
ويتحدث عن اجتماع السلاجقة على زعامة طغرل بك، وتوسع دولتهم، واعتراف الخليفة العباسي بهم.
ويتكلم هذا الكتاب عن النفوذ الفاطمي العبيدي في العراق وفتنة البساسيري، وعقيدة الدولة الفاطمية والعبيدية، وصلتها بالقرامطة.
ويتضمن هذا الكتاب سيرة السلطان السلجوقي: ألب أرسلان، والذي تولى السلطة بعد طغرل بك، وعن جهاده في سبيل الله، وحملته على الشام وضم حلب، وعن انتصاره الشهير الكبير في معركة ملاذكرد سنة (463 هـ) على الروم، ووقوع ملكهم في الأسر، وما ترتب على تلك المعركة من نتائج.
المشروع السني
ويبرز الكتاب المشروع السني الذي قام به الوزير السلجوقي نظام الملك في عهد ألب أرسلان وملكشاه، ويفصل في سيرة هذا السياسي الكبير، فيتحدث عن ضبطه لأمور الدولة، والتصور النظري عنده لها، واهتمامه بالتنظيمات الإدارية، والبعد الاقتصادي، وعنايته بالمنشآت المدنية، ودورهِ في النهوض بالحركة العلمية والأدبية، وعن عبادته، وتواضعه، ومدح الشعراء له، وعن وفاته وتأثر أهل بغداد والمسلمين بوفاتهِ.
ويمضي الكتاب مع القارئ إلى عهد التفكك، وضعف وانهيار الدولة السلجوقية، ويشير إلى الصراع بين بركيارق بن ملكشاه، وتركان خاتون زوجة أبيهِ التي قاتلت من أجل تولي السلطنة ابنها محمود الطفل الصغير، ويفصل الكتاب في الصراعات الداخلية والقتال الذي حدث داخل البيت السلجوقي، ووفاة بركيارق بن ملكشاه، وتولي محمد بن ملكشاه السلطنة.وتناول الكتاب سيرة الخليفة المستظهر بالله، وسيرة السلطان السلجوقي سنجر بن ملكشاه، والصراع الداخلي في البيت السلجوقي على السلطنة، وسيرة السلطان مسعود ابن محمد بن ملكشاه، وصراعه مع الخليفة العباسي المسترشد بالله الذي حاول انتزاع حقوق الخليفة من السلاطين السلاجقة، وإعادة هيبة الخلافة؛ إلا أنه وقع في الأسر.
وتحدثت عن مظاهر السيطرة السلجوقية على الخلافة العباسية، والتي منها: نقل مقر الحكومة خارج بغداد، وتفويض السلطة من الخليفة إلى السلطان السلجوقي، وتدخل السلاجقة في ولاية العهد، وحرمان الخلافة العباسية خلال فترة السيطرة السلجوقية من إعادة تشكيل الجيش، وتكلمت عن بداية انتعاش الخلافة العباسية في عهد المقتفي لأمر الله المتوفى (555 هـ)، والذي سيأتي الحديث عنه بإذن الله عند حديثنا عن الزنكيين. وأشرت إلى نهاية الدولة السلجوقية، وأسباب زوالها.
وفي الفصل الثاني: تطرقت إلى نظام الوزارة العباسية في العهد السلجوقي، وعن صفات وزير الخليفة العباسي من العلم، والرأي السديد، والعدل، والكفاية، والسياسة، والشؤون الدينية، وقوانين الوزارة، والبلاغة، وحسن الترسل، والمحبة لدى العامة، والخاصة، والمعرفة بقواعد ديوان الخلافة.
وفي الفصل الثالث: اهتممت بالمؤسسة العسكرية السلجوقية والتي كانت القوى الضاربة للدولة، ففصلت في أسس الإدارة العسكرية السلجوقية، كالتنشئة العسكرية للأبناء، والجهاد في سبيل الله، والحرص على كسب ولاء الجيش وقادته، والخبرة والتجربة، والإخلاص والتضحية، والحيطة والحذر والمتابعة، والعلاقة بين الجند وقادتهم، والتدرج في الرتب العسكرية.
كما تحدثت عن نظم الإدارة العسكرية كالمناصب القيادية، كالأمير الحاجب الكبير، وصفات قائد الجيش، ورواتب الجند، والقائد العام، وأمير الحرس، والمقدم، والعميد، والأتابك، وقاضي العسكر، وديوان عرض الجيش؛ وتحدثت عن الأسلحة الهجومية، وأسلحة الوقاية والدفاع عن النفس، وأسلحة العرض والزينة، ونظام حماية المدن ووسائل الحصار، وصناعة الأسلحة، وخزائنها، والخطط والفنون القتالية عند السلاجقة؛ كالقدرة على التحرك، مثل: السرعة، واستخدام الكمائن، والتراجع الزائف، وخطة تطويق العدو، والمباغتة والمفاجأة والرمي بالسهام، والالتحام مع العدو، والاستنزاف، وسياسة الأرض المحروقة، والتأثير على جيش العدو، والسيطرة على الطرق، وعلى موارد المياه، والتأمين العسكري، والمهام الخاصة الطارئة والحربية والحراسة، ونظام التعبئة، وأفردت مبحثاً عن أثر نظم السلاجقة في الدولة الزنكية، والأيوبية، والمماليك، وقد تأثرت كذلكَ الدولة العثمانية بتلكَ النظم العسكرية، وقد أشرتُ إلى دور المرأة في العهد السلجوقي.
وفي الفصل الرابع: كان الحديث عن المدارس النظامية مُنذ نشأتها، وعن أهدافها التعليمية، ووسائل نظام الملك في تحقيق أهداف المدارس، كاختيار الأماكن والأساتذة والعلماء، وتحديد منهج الدراسة، وتوفير الإمكانات المادية.
وقد قامت المدارس النظامية على فقه الإمام الشافعي، وتراثه في الأصول والفقه، كما كان لتراثهِ تأثير كبير في المدارس النظامية، ولذلكَ رأيتُ من المناسب أن نعرف بهذا الإمام الكبير، فذكرت شيئاً من سيرته، وأصولهِ في إثبات العقيدة، ومنهجهِ في إثباتها، كحقيقة الإيمان، ودخول الأعمال في مُسَمَّاه، وزيادة الإيمان ونقصانهِ، وحكم مرتكب الكبيرة، وتوحيد الألوهية، وطريقته في الاستدلال على وجود الله، وتوحيد الأسماء والصفات، وعقيدته في الصحابة، وعناصر المنهج في فقه الإمام الشافعي.
مناهج أهل السنة
وقد بينت المراحل التي مرّ بها، وكيف استقر في المرحلة الثالثة على أصول منهج أهل السنة والجماعة، وتحدثت عن سرّ عظمة الأشعري في التاريخ، ووضحت عقيدته التي يدينُ بها، وآخر ما مات عليه من معتقد، وأثر تراثه في المدارس النظامية، وكيفَ امتد ذلكَ التأثير في عهد الأيوبيين، والمماليك، والعثمانيين.
وترجمت لإمام الحرمين عبد الملك الجويني، وأشرت إلى ثناء الناس عليه، وأهم أخلاقه وصفاته، وذكرتُ القيمة العلمية لكتاب الإمام الجويني (غياث الأمم)، وعودته إلى مذهب السلف، ورجوعه عن علم الكلام، ونهيه أصحابه عنه، ومؤلفاته في العقيدة، والفقه، وأصوله، والخلاف، والجدل، والسياسة.
وترجمت للإمام الغزالي الذي كان من كبار الأساتذة في المدارس النظامية، وتحدثت عن اجتهاده في طلب العلم، وملازمته إمام الحرمين، وتعيينه مدرساً على نظامية بغداد، وعن أسباب نبوغ الغزالي وشهرته
وموقفه من الفلاسفة، والفلسفة، وعلم الكلام، والتوصف، ومنهجه الإصلاحي، وصفات هذا المنهج، وتشخيصه لأمراض المجتمع، وتكلمت عن ميادين الإصلاح عنده، ووضع منهاج جديد للتربية والتعليم، وبناء العقيدة الإسلامية، وإحياء رسالة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونقد السلاطين الظلمة، والدعوة للعدالة الاجتماعية، ومحاربة التيارات الفكرية المنحرفة، وأشرت إلى دوره في إصلاح الفكر، كدور العقل، ورفض التقليد، والدعوة إلى الكتاب والسنة، والالتزام بمنهج السلف، وعن موقفه من الاحتلال الصليبي.
وفي الفصل الخامس: تحدثت عن الحروب الصليبية في العهد السلجوقي، فتحدثت عن الجذور التاريخية للحروب الصليبية، وأهم أسباب ودوافع هذا الغزو، كالدافع الديني، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وتبدل ميزان القوى في حوض المتوسط، واستنجاد إمبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثاني، وشخصية البابا أوربان
الثاني، ومشروعه الشامل للغزو الصليبي، والخطبة التي ألقاها أوربان الثاني، ونتائج مهمة من خطاب البابا، كتدعيمه خطابه بعدد من النصوص الواردة في الكتاب المقدس، وترتيب الأولويات عنده، وقدرته على تقديم مشروع عام استوعب طاقات غرب أوروبا، وتحريكه لاحتلال بلاد الشام والهيمنة على المشرق، ووصف بدء الحرب الصليبية الأولى ابتداء من حملة العامة الغوغاء ومروراً بحملة الأمراء، وموقف الإمبراطور البيزنطي من ذلك، وسقوط نيقية، ومعركة دوريليوم، وسقوط قونية، وهرقلة، وإمارة الرها، وإمارة إنطاكية، وبيت المقدس، وطرابلس، وصيدا.
وحللت أسباب نجاح الحملة الصليبية الأولى، وبينت أهم أسبابها، كانعدام الوحدة السياسية في العالم الإسلامي، والصراع على السلطنة في داخل البيت السلجوقي، ووجود الدولة الفاطمية، وسقوط الخلافة الأموية بالأندلس.
وأفردت مبحثاً عن حركة المقاومة الإسلامية في العهد السلجوقي فيما بين الغزو الصليبي وظهور عماد الدين زنكي، وعن دور الفقهاء، والقضاة، واستجابتهم لمقاومة الغزو، وتحريضهم على الجهاد بالكتابة، والتأليف، والمشاركة الفعلية في ساحات الجهاد.
وتطرقت لجهود الشعراء ودورهم في حركة المقاومة، وأنصفت قادة الجهاد من السلاجقة قبل عماد الدين، كجهاد قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل، وجكرمش صاحب الموصل، وسقمان بن أرتق صاحب ماردين وديار بكر، ومعركة البليخ، وانتصار المسلمين على الصليبيين، ونتائج تلك المعركة، وتحدثت عن الأعمال الجهادية التي قام بها قلج أرسلان في آسيا الصغرى، ومعركة مرسيفان، وهرقلة الأولى والثانية.
