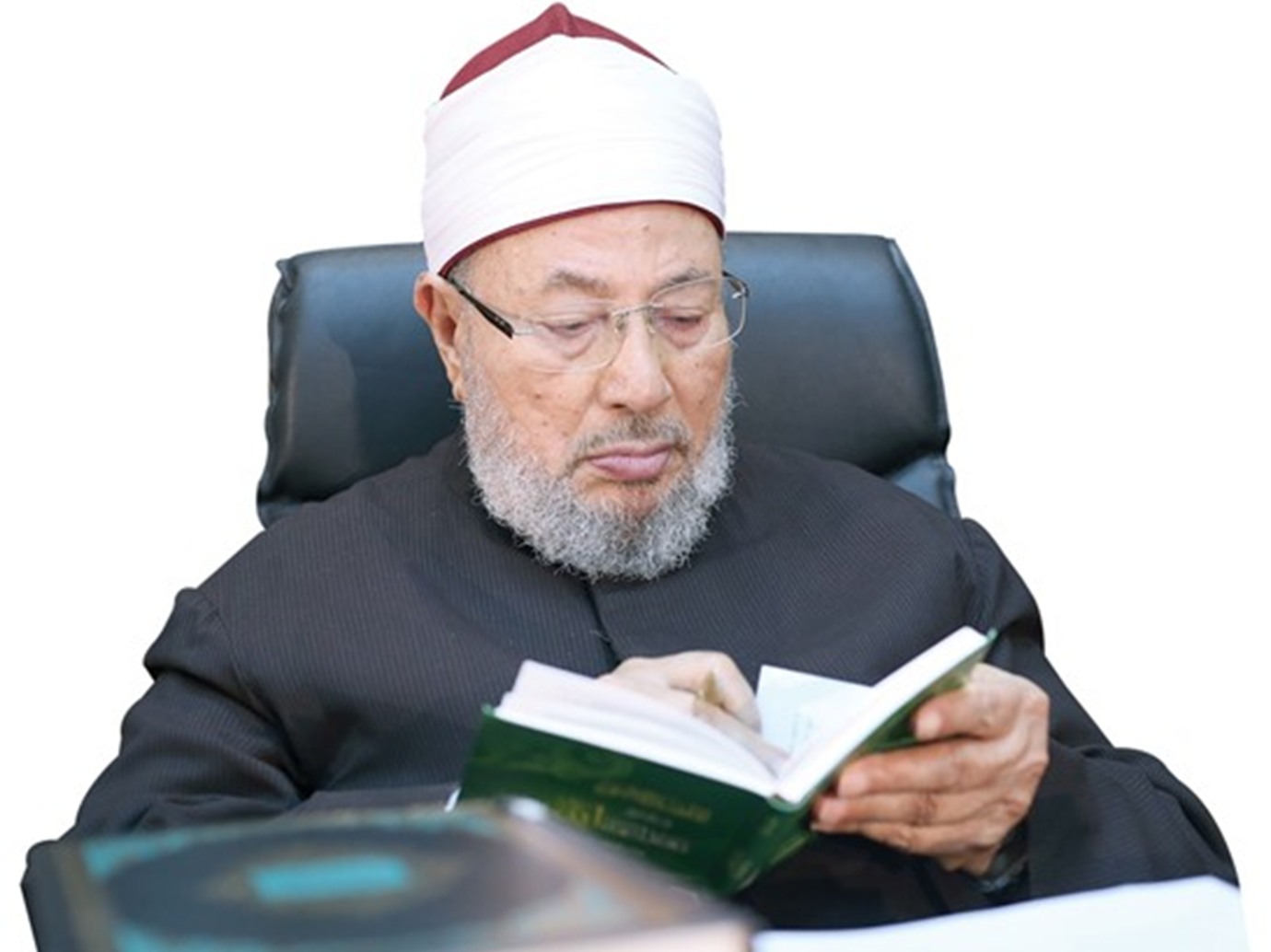«العرب» تنفرد بتفسير جزء تبارك للشيخ القرضاوي
الصفحات المتخصصة
22 أكتوبر 2015 , 03:23م
العرب
تعلم التوحيد يكون عن طريق القرآن والعقل والفطرة
{وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا}.
معطوف على {مَنْ لَمْ يَزِدْ مَالُه}؛ لأن المتبوعين هم الذين مكروا، وقالوا للأتباع: {لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ}. وهؤلاء هم الذين مكروا.
والمكر كما قال الراغب في (مفردات القرآن): هو صرف الغير عمَّا يَقصِده بحيلة، وذلك ضرْبان: مكر محمود، وذلك أن يُتَحَرى بذلك فعل جميل، وعلى ذلك قال تعالى: {واللهُ خَيْرُ الماكِرِينَ} [آل عمران:54]، ونوعٌ مذموم، وهو أن يُتَحَرَّى به فعل قبيح، قال تعالى: {وَلَا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إلاَّ بِأَهْلِهِ} [سورة فاطر:43]( ).
وهؤلاء الكبراء مكروا بالبسطاء والضعفاء من الناس مكرًا كُبَّارًا، أي: مكرًا عظيمًا هائلًا، بدلالة الصيغة ذاتها، تقول: مكرا كبيرًا، وكُبَارًا، وكُبَّارًا، تعظِّمه وتضخِّمه، والعرب تقول: أمر عجيب وعُجَاب وعُجَّاب، ومثل ذلك: حُسَان وحُسَّان، وجُمَال وجُمَّالٌ، وقُرَّاء للقارئ، ووُضَّاء للوَضِيء. وأنشد ابن السِّكِّيت:
بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحُسْن قلبَ المسلمِ القُرَّاء
ثم ذكر شيئًا من ذلك المكر، بقوله: {لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ} أي: لا تـتركُنَّ عبادتها، ثم خصُّوا بعضَها بالذِّكر لتميُّزها عندهم، وقالوا: {وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}.
قال الرازي: (المكر الكُبَّار، هو أنهم قالوا لأتباعهم: {لاَ تَذَرُنَّ وُدًّا} فهم منعوا القوم عن التوحيد، وأمروهم بالشِّرك، ولما كان التوحيد أعظم المراتب، لا جرم كان المنع منه أعظم الكبائر. فلهذا وصفه الله تعالى بأنه كُبَّار، واستدل بهذا من فضَّل علم الكلام على سائر العلوم، فقال: الأمر بالشرك كُبَّار في القبح والخزي، فالأمر بالتوحيد والإرشاد، وجب أن يكون كُبّارًا في الخير والدين).
يقول القرضاوي: ولكن أن يكون تعلم التوحيد عن طريق القرآن وما يسنده من العقل والفطرة.
وتكلم الرازي في مسألة أخرى في هذه الآية، وهي: أنه تعالى إنما سماه (مكرًا) لوجهين: الأول: لما في إضافة الإلهيَّة إليهم من الحيلة الموجبة لاستمرارهم على عبادتها، كأنهم قالوا: هذه الأصنام آلهة لكم، وكانت آلهة لآبائكم، فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالّين كافرين، وعلى آبائكم بأنهم كانوا كذلك، ولما كان اعتراف الإنسان على نفسه، وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجهل شاقًّا شديدًا، صارت الإشارة إلى هذه المعاني بلفظ آلهتكم صارفًا لهم عن الدين، فلأجل اشتمال هذا الكلام على هذه الحيلة الخفية سمى الله كلامهم (مكرًا).
الثاني: أنه تعالى حكى عن أولئك المتبوعين أنهم كان لهم مال وولد، فلعلهم قالوا لأتباعهم: إنَّ آلهتكم خير من إله نوح؛ لأن آلهتكم يعطونكم المال والولد، وإله نوح لا يعطيه شيئًا؛ لأنه فقير. فبهذا المكر صرفوهم عن طاعة نوح. وهذا مثل مكر فرعون إذ قال: {أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ} [الزخرف:51]. وقال: {أَمْ أَنَا خَيْرٌ مّنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ * فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مّن ذَهَبٍ} [الزخرف:52-53]( ).
وقال ابن كثير في تفسير (المكر الكُبَّار): (والمعنى في قوله: {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} أي: باتباعهم في تسويلهم لهم بأنهم على الحق والهدى، كما يقولون لهم يوم القيامة: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا} [سبأ:33].
{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}.
وهذه أسماء أصنامهم أو آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله.
روى البخاري بسنده عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدُ، أمَّا وَدّ: فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سُواع: فكانت لهذيل، وأما يغوث: فكانت لمراد، ثم لبني غُطَيف بالجُرُف عند سبأ، أما يُعوقُ: فكانت لهَمْدان، وأما نسر: فكانت لحِمْيَر لآل ذي كَلاع. وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح- عليه السلام-، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن: انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا، وسمُّوها بأسمائهم. ففعلوا، فلم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك وتَنَسَّخَ العلم عُبِدت( ).
وكذا رُوي عن عكرمة، والضحَّاك، وقتادة، وابن إسحاق، نحو هذا.
وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح( ))( ).
{وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا}.
فهؤلاء الكبراء من قوم نوح ظلُّوا على تضليل أتباعهم من أصاغر الناس والمستضعفين منهم، وقد أضلوا كثيرًا منهم بفتنتهم، ولهذا دعا عليهم نوح، فقال لربِّه: {وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا} [نوح:24]، فقد يئس منهم، ولم يعد عنده أدنى طمع في أن يؤمنوا ويرجعوا عن كفرهم، ويعترفوا بأنَّ الله هو الذي خلقهم ورزقهم، فلا غرْو أن يدعو عليهم كما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه وجنده: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس:88].
وقيل: إن الإضلال في قوله: {وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا}: إنما هو للأصنام، وهو شبيه بقول إبراهيم بعد أن دعا ربه فقال: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم:35]. ثم قال: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ} [إبراهيم:36]. فيمكن أن ينسب الإضلال إلى هذه الأصنام، وهذه الحجارة التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل، فأجراها مجرى الآدميين، لما يقع عند كثيرين من الفتنة بها.
{مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا * وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا * رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا}.
مصير قوم نوح وعاقبة مكرهم :
بهذا الشوط تنتهي هذه السورة التي نرى فيها صورة من جهاد شيخ المرسلين نوح- عليه السلام-، مع هؤلاء الناس الجاحدين العتاة غلاظ القلوب، الذين ضلت عقولهم، وعميت بصائرهم، والذين ظلَّ نوح يجادلهم ويعاودهم ليلًا ونهارًا، وسرًّا وجهارًا، ويجتهد بكل طاقته العقليَّة والنفسيَّة والروحيَّة، ليخرجهم من هذه الحجرية الصلدة، ويفكهم من الحبل الغليظ الذي يربطهم بجاهليتهم، التي صنعوها هم، وكانوا أول من صنعها للناس، ولكن نوحًا على الرغم من فصاحة لسانه، وبلاغة كلامه، وتنوع بيانه، لم يستطع أن يغير هذا النشاز السميك، الذي يسدُّ آذانهم، ويغطِّي وجوههم وعقولهم.
ولهذا قال الله تعالى هنا: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ} أي: بسبب خطيئاتهم ومساوئهم المتعددة والمتنوعة.
وكلمة (ما) زائدة من الناحية الإعرابية، كما قال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} [المائدة:13].
وقوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [آل عمران:159].
فيقول تعالى هنا: من أجل هذه الخطايا والذنوب والمعاصي التي ظهر خبثها، وفاحت روائحها المنتنة، عمَّهم الله تعالى بالإغراق، الذي تبعه الإحراق: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا} هذا هو الحكم الذي حكم الله سبحانه به عليهم من فوق سبع سماوات، بعد أن صبر عليهم وحلم عليهم كل هذه الفترة الكبيرة.
إثبات عذاب القبر:
تمسَّك أهل السنة بالآية الكريمة وغيرها في إثبات عذاب القبر، كما صحَّت به الأحاديث، وجاءت به الآيات الأُخُر.
ومن ذلك ما جاء في الآية الكريمة هنا: {أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا} فعطف دخول النار على الإغراق، بحرف الفاء {فَأُدْخِلُوا} والفاء في اللغة العربية، تفيد والترتيب والتعقيب بلا مهلة. فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة؛ لأن دخول النار حدث عقب الإغراق.
وما يعترض به بعض الناس من أن الميِّت من الكفار أو المجرمين العتاة يغرق، ونعلم أنه من أصحاب الجحيم، ولكنه يظل في البحر لا يخرجه أحد، أو في الطوفان عدة أسابيع، أو أشهر، فكيف يجتمع الماء والنار؟
والجواب: أنا نقول: النعيم والعذاب في القبر، أو في الحياة البرزخية؛ ليست كما هي في الحياة الآخرة، بل هي حياة أخرى، ربما يكون العذاب فيها للكيان الروحي والعقلي للإنسان، وليس للكيان الجسدي، الذي قد يتفتَّت أو يُذرَّى في الهواء أو غير ذلك. ولكن الله تعالى قادر على أن يوصِّله لأصله الإنساني- الذي هو أساس تكوينه وتكليفه- ولا بد، في الحياة البرزخية، كما قال تعالى في الشهداء: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [آل عمران:169-170].
وقال تعالى عن قوم فرعون الذين أغرقهم الله أجمعين: {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر:45-46].
وقال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} [الأنعام:93].
م.ب